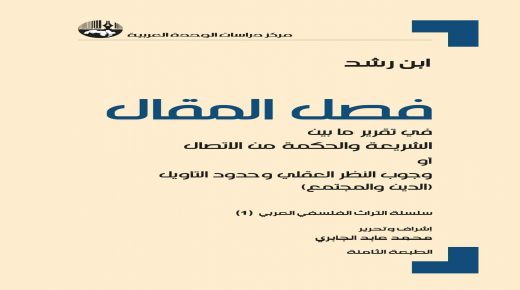بقلم الاستاذ عبد الرحيم الراجي باحث بسلك الماستر بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط.[/prosco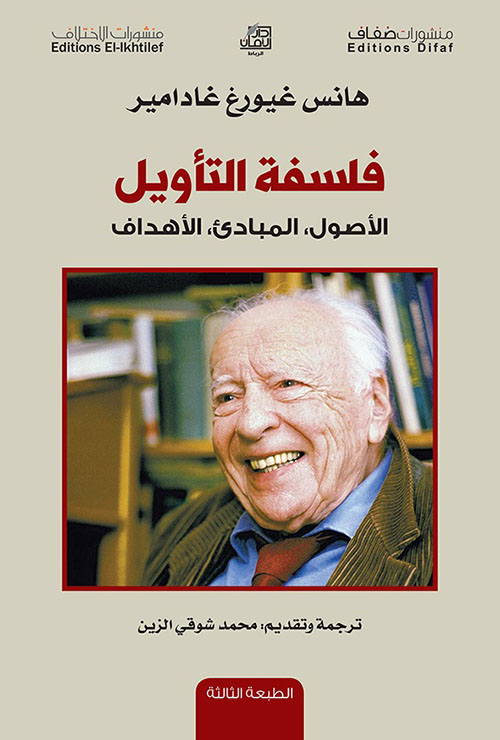
إذا كانت الحضارة الإنسانية قد انبنت أسسها وقامت علومها وثقافتها على أساس العقل والنص كما هو الأمر بالنسبة للحضارة العربية الإسلامية والحضارة الغربية ، فإن التأويل كان ولا يزال حاضرا كآلية عند العديد من المفكرين العرب والغربيين، في مساءلة النص الديني وفهمه وتكييف دلالاته ومعانيه مع حاجيات و انتظارات المجتمعات العربية والغربية التي تعرف تحولات مستمرة، ودليلنا على أهمية موضوع التأويل واستمرارية الانشغال به في إطار الإشكالية الكبرى المتعلقة بالحفاظ على التراث وتجديده ، يتجسد بوضوح في العديد من الكتابات التي تضمنت الحديث عن التأويل مثل: كتاب ” فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال” لابن رشد و كتاب” إلجام العوام عن علم الكلام” للغزالي وكتاب “فلسفة التأويل” للفيلسوف هانز جورج غادامير. الأسئلة المطروحة الآن هي: هل كلمة التأويل لها حضور في “القرآن بوصفه نصا لغويا مركزيا في الثقافة العربية” ؟ علاوة على ذلك، ما هو مفهوم التأويل في التداول اللغوي و الاصطلاحي؟
1- مفهوم التأويل في الاستعمال القرآني
وردت لفظة “التأويل” في القرآن سبع عشرة مرة، مما يدل على استخدامها بكثرة، وهذا الاستخدام كان بمعان مختلفة، إذن لننتقل إلى ذكر السور والآيات والمعاني التي أخدتها لفظة التأويل:
1- وردت لفظة التأويل في سورة آل عمران مرتين، قال تعالى: “هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشبهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله و الراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا وما يذَّكَّر إلا أولو الألباب” الآية كما هو ملاحظ تتضمن كما يقول السيوطسي” الحديث عن المحكم والمتشابه من الآيات، والمحكم هو ما أحكم معناه، بحيث لا يحتمل وجوها من التأويل أما المتشابه فهو غير الواضح الغامض والملتبس الذي يحتمل وجوها للتأويل” والتأويل في الآية المذكورة يفيد في نظر الطبري العاقبة .
2- في سورة النساء وردت لفظة تأويل مرة واحدة في قوله تعالى: ” يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا” والملاحظ في الآية أن المعنى يدور حول نزاع المسلمين مع أولي الأمر وبالتالي رد النزاع والفصل فيه إلى الله ورسوله لأن ذلك من الإيمان، ومن هنا يقول الطبري أن” “أحسن تأويلا” أي جزاء، وهو الذي صار اليه القوم وقالوا أحسن عاقبة ومصيرا” فمعنى التأويل في هذه الآية هو عاقبة الأمر ومصيره.
3- في سورة الأعراف وردت كلمة تأويل مرتين في قوله عز وجل: “هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل لقد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون” ومدار الأمر في هذه الآية هو وجوب تدبر كتاب الله والعمل به لأنه هدى وشفاء كما قال عنه لله عز وجل، ولكن الكفار يعاندون وسيدرك هؤلاء صدق هذا الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك لا يخرج معنى التأويل هنا عن معنى العاقبة والمصير، ووقوع ما أخبر عنه وذلك يوم القيامة، فيقول الكافرون ” قد جاءت رسل ربنا بالحق” فقد صدق الرسل بما جاءت ولكن الكفار أصروا على كفرهم وعلى انتظار يوم القيامة ومن هنا فمعنى التأويل هنا هو العاقبة أيضا.
4- في سورة يونس وردت لفظة تأويل مرة واحدة في قوله تعالى: “بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين” و مدار الآية على ما قام به الكفار من تكذيب لما جاء في القرآن قبل الإحاطة بما فيه، وقبل أن يأتيهم ما يؤول اليه الأمر من صدق القرآن ووقوع ما أخبر به، وبالتالي يكون معنى التأويل في هذه الآية هو المآل بمعنى المرجع والمصير.
5- في سورة يوسف وردت كلمة تأويل في ثمانية مواضيع مختلفة من السورة أولها: حين أخبر يوسف أباه عما رآه في منامه فيقول تعالى: ” إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين” هذه الرؤيا التي شكلت منعرجا محوريا في حياة يوسف، فتنبأ أبوه بمستقبله فبشره قائلا: “وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها من قبل على أبويك إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم” وليس تأويل الأحاديث إلا تأويل الأحلام، وهذا يظهر بشكل جلي من خلال تأويل حلمي السجينين وحلم الملك، وكلها قد تحققت، مما يدل على ارتباط التأويل في الآية بالإخبار بالأمر الذي سيقع في المآل من تحقق الرؤى والأحلام. وكذلك جاء بنفس المعنى قوله تعالى: ” وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث” كذلك قوله تعالى:” ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إنِّ أراني أعْصِرُ خمرا وقال الآخر إنّْي أرَاني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل منه الطير نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين” ففي كلتا الحالتين الآيتين تحمل كلمة تأويل معنى الإخبار عما سيقع، فكلمة تأويل في سورة يوسف جاءت في كل المواضيع مقترنة بالأحلام والرؤى، فدلت على الأمر الذي سيقع في المآل من تحقق الأحلام، سواء رآه يوسف في منامه أو ما عرض عليه من أحلام طلبا لمعرفة حقيقتها كما أشرنا سابقا وبقي أن نذكر المواضيع الأخرى التي ذكرت فيها كلمة تأويل، قال تعالى :” قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلك مما علمني ربي” ، وفي قوله تعالى:” قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالم” كذلك قوله عز وجل:” وقال الذي نجا منهما واذكر بعد أمة أنا أنبكم بتأويله فأرسلون” وقوله أيضا: ” يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا” وقوله: “رب قد آتيتني من المُلك و علمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين”. إذن كلمة تأويل في سورة يوسف تتوزع معانيها كما وضح المفكر المصري نصر حامد أبو زيد “بين تأويل الرؤى والأحلام وتأويل الأحاديث بمعنى الإخبار عن الأشياء قبل حدوثها”.
6- في سورة الإسراء ذكرت كلمة تأويل مرة واحدة، قال تعالى: “أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا” ففي الآية أمر بالإحسان في البيع وذلك بإيفاء الكيل، والعدل في الميزان، فذلك خير وأحسن تأويلا أي عاقبة، وعلى ذلك فالاستخدام القرآني للتأويل في الآية بمعنى العاقبة.
7- والموضع الأخير الذي وردت فيه كلمة تأويل هو سورة الكهف ووردت مرتين على لسان الخضر الذي اشترط على موسى أثناء مصاحبته له الصبر، فقال تعالى: ” قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا” فكشف الخضر عن السبب والدافع وراء هذه الأفعال التي أقدم عليها والآية الثانية ويقول فيها الله تعالى” ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ” إذن التأويل في الآيتين يتعلق بالكشف عن الدلالة الخفية للأفعال التي قام بها الخضر بالرجوع إلى أصولها وبيان السبب الحامل عليها، وبالتالي الإنباء بأمور عملية ستقع في المآل.
استقراء المعطيات السابقة تقودنا استنتاج فكرة مؤداها، أن القرآن الكريم استعمل التأويل بمعنى: العاقبة والمآل والإخبار والكشف عن الدلالة الخفية للأفعال وبيان السبب الحامل عليها. السؤال الذي يطرح الآن هو: ما هو المدلول اللغوي والاصطلاحي للتأويل؟
2- مفهوم التأويل في التداول اللغوي و الاصطلاحي
أ- الدلالة اللغوية للتأويل
يعد التأويل من الناحية اللغوية ظاهرة لها أهميتها في تاريخ الفكر الإنساني بصفة عامة وفي تاريخ الفكر العربي بصفة خاصة، وبالنظر إلى أهميته على مستوى فهم النصوص الدينية في الكتب السماوية، سنعمل على رصد مختلف معانيه اللغوية وفق ما هو مبين تحته:
– التفسير والتدبر: يذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى(ت 210هـ) صاحب “مجاز القرآن” أنّ: التفسير والتأويل بمعنى واحد فنقول: تأولت في فلان الأمر أي تحرّيته وتدبّرته” وتجدر الإشارة إلى أن معنى التأويل عند الصحابة والتابعين لا يخرج عن معنى التفسير والتدبر، ومن هذا المفهوم كانت ” دعوة الرسول لابن عباس: “اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل”
فالتأويل الذي استخدمه ابن عباس لا يخرج عن كونه معرفة تفسير معاني الآيات وإن تطلب ذلك التدبر وإعمال العقل ” فإن السلف قد قال كثير منهم أنهم يعلمون تأويله… ونقلوا ذاك عن ابن عباس أنه قال: (أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله) وهذا يقتضي أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل الصحيح للمتشابه وهو التفسير في لغة السلف.
– الرجوع: جاء في معجم تهذيب اللغة للأزهري(ت 370 هـــ)أن: “الأول هو الرجوع، وقد آل يؤول أولا أي رجع” وعلى هذا يكون التأويل مأخوذا من الأول بمعنى الرجوع، فكأن المؤول أرجع الكلام إلى ما يحتمله من معان.
– العاقبة: جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس(ت 395 هـ): أن التأويل يعني جهة الرجوع ويعني من جهة أخرى العاقبة أي ما يؤول إليه الأمر”
– الإصلاح والسياسة: جاء في لسان العرب لابن منظور(ت 711هـ):”آل مآله إيالة إذا أصلحه والإئتيال يعني الإصلاح والسياسة” كما جاء في مادة (أول) مرتبطا بالتففة والتدبر في نصوص القرآن الكريم، فـ”أول الكلام وتأوله : دبَّره وقدَّره. و المراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى تدليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ”.
بناء على ما تقدم، يمكن القول أن مدلول” التأويل ” في المعاجم اللغوية يتمحور حول المعاني الآتية: الرجوع، العاقبة، السياسة، التدبر و التفقه. و الملاحظ أن هذا المعنى قد صاحب الخطاب الديني منذ بداية الوحي، ومحاولة المسلمين فهم القرآن فهما صحيحا يمكنهم من استنباط أحكام و مقاصد الشرع، إذن ماهو المدلول الاصطلاحي للتأويل؟.
2- الدلالة الاصطلاحية للتأويل
أ- التأويل عند المفكرين العرب : النص الديني الذي يوهم المتلقي بالتشبيه والتجسيم يقتضي في نظر الفقهاء التـأويل أو التفويض، لكن ما ينبغي أن نومئ إليه هو أن التأويل أضحى مدار اهتمام ونقاش كبير في المجتمع العربي الإسلامي نتيجة عوامل عدة ارتبطت: بالصراع السياسي على السلطة وظهور الفرق الكلامية وتطور الوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي نتيجة الانفتاح على حضارات أخرى مثل: الحضارة الفارسية والحضارة اليونانية والحضارة الهندية…إلخ.
– إدن في هذا السياق التاريخي، ذكر الفيلسوف أبو حامد الغزالي (450هـ – 505هـ) في كتاب “إلجام العوام عن علم الكلام” تعريفا للتأويل عند ما كان بصدد حديثه عن الألفاظ والأخبار الموهمة للتشبيه، مبرزا” بأن التأويل هو بيان معنى اللفظ بعد إزالة ظاهره وهذا إما أن يقع من العامي مع نفسه أو من العارف مع العامي أو مع العارف بنفسه بينه وبين ربّه”. وهذا ما ذهب إلى تأكيده في “المستصفى” إذ أوضح أن ” التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل، يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر ويشبه أن يكون كل تأويل صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز” ، على ضوء هذا التعريف الذي قدمه الغزالي نستنج أن الرجل، كان يهتم بالتأويل المجازي وهو صرف اللفظ عن ظاهره.
– من المنظور الفلسفي دائما، عرّف أبو الوليد بن رشد(520هـ – 595هـ) من خلال كتابه “فصل المقال” التأويل بالقول:” ومعنى التأويل: هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، من غير أن يخل ذلك بعادة اللسان العربي في التجوز”.
– أخذا بوجهة نظر علماء الكلام في تعريف التأويل، يقول المؤرخ والمتكلم محي الدين يوسف بن عبد الرحمان بن الجوزي (510هـ – 597هـ)معرفا التأويل:” التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لاعتضاده بدليل يدل على مراد المتكلم “.
– في نفس الاتجاه، حدد المتكلم والمتصوف علي بن محمد الحسيني الجرجاني(730هـ – 816هـ) التأويل قائلا:” التأويل في الأصل الترجيح وفي الشرع صرف الآية عن معناها الظاهر إلى معنى يحتمل الذي يراه موافقا بالكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: “يخرج الحي من الميت” إن أراد به إخراج الطير من البيضة كان تفسيرا، وإن أرد إخراج المؤمن من الكفر أو العالم من الجاهل كان تأويلا”.
ب-التأويل عند المفكرين الغربيين: إذا كانت تجربة التفكير العربي في التأويل تتوخى حسب السياق تحقيق هدف من الأهداف الثلاث الآتية : استدعاء التأويل بهدف التعضيد أو التسديد أو التجديد، فإن رهان الفيلسوف الهيرمينوطيقي أمثال شلاير ماخر وهانز جورج غادامير وغيرهم كان يركزعلى تمثل التأويلية أو الهيرمينوطيقا على أساس أنها إبداع وتجديد، لأن جل فلاسفة الهيرمينوطيقا تصورا التأويلية بأنها مرادفة لفن الفهم الذي ييسر رفع سوء الفهم بالاعتماد عل القاعدة اللغوية والسيكولوجية وما إلى ذلك، ضدا على المنهج التفسيري الذي ظلت تنادي به النزعة الوضعية في مجال العلوم الطبيعية.
– إذن انسجاما مع هذه الرؤية الجديدة التي أضحت تتكلم عن التأويلية وليس التأويل، عرّف الفيلسوف الألماني شلاير ماخر(1768م- 1834م) التأويلية (الهيرمنوطيقا) بالقول بأنها ” فن الفهم أي الفن الذي لا يمكن الوصول إلى الفهم إلا من خلاله”
– تأكيدا لفكرة فنيّة التأويلية التي أشار إليها شلاير ماخر، أوضح هانز جورج غادامير من خلال مؤلفه “الحقيقة والمنهج” قائلا:” التأويلية هي فن الفهم الذي يعول على السبيل اللاهوتي والسبيل الفيلولوجي في العودة إلى التراث بغرض اكتشاف وفهم الكتاب المقدس والأدب الكلاسيكي”.
اسنتاج: استقراء المعطيات السابقة، يجعلنا نستوعب أن التأويل بتعبير المتكلمين والفلاسفة هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح مع قيام الدليل القاطع على أن ظاهره محال، أو هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، أما التأويلية فهي فن الفهم الذي يستوجب تجاوز سوء الفهم بالمراهنة على القاعدة اللغوي والقاعدة السيكولوجية بتعبير شلاير ماخر.