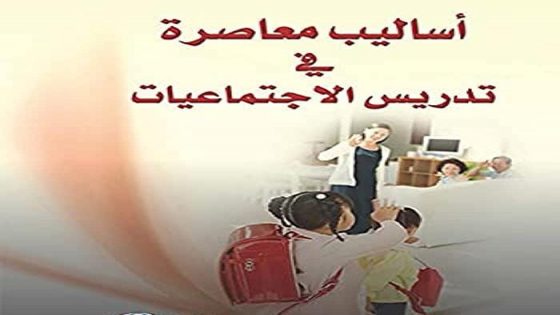عبد الرحيم نسامي
إن هاجس الارتقاء بالعرض المدرسي بالتعليم الثانوي والسعي نحو نجاعة المناهج الدراسية وجودة المضامين والرفع من مردودية التعلمات ووظيفيتها، يستدعي لا محالة بلورة نموذج بيداغوجي جديد بتطوير للمناهج والبرامج الدراسية ، ومن هذا المنطلق نقترح هذه الورقة كإضاءات قد تسهم في تطوير مواد الاجتماعيات، في سياق الإعداد لاستكمال التجديد الذي تشرف عليه مديرية المناهج منذ شهر يناير الماضي والخاص بالسلك الثانوي الإعدادي. والذي يتغيى وضع الأسس لتحقيق الإصلاح المنشود في إطار ما اصطلح عليه بالنموذج التنموي الجديد.
ويأتي هذا الورش بعد أن عمَّرت المناهج والبرامج الحالية أكثر من عقدين من الزمن. وبالنظر إلى بعض ما أسفرت عنه تجربة تجديد برامج ومناهج السلك الابتدائي من نقائص وتعثرات عديدة، نود أن ننبه إلى ملاحظات عديدة:
1ـ بالنسبة لمادة التاريخ:
تكاد تجمع كل الدراسات، والتي اتخذت التاريخ المدرسي موضوعا لها، على أن تدريس المادة يعتريه بعض جوانب القصور. إذ أن تدريس مادة التاريخ بالمدرسة المغربية يطرح نقاشا حول أزمة منهجية وهيكلية تستلزم من الجميع تكثيف الجهود لتجاوزها (عز العرب معنينو، 2012، ص: 41).
فعلى المستوى المعرفي يلاحظ أن بعض المعارف التاريخية المرتبطة بالتاريخ القديم مثلا تُجوِزت، وتفترض تحيينا واطلاعا مستمرا على مستجدات البحث الأثري(إنسان إيغود مثلا) الذي كثيرا ما يفند أو يدعم بعض النظريات(س. محمد العيوض، 2012 ص: 52). كما أنه من غير المعقول هيكليا أن يتم تدريس التاريخ في القرن الواحد والعشرين بمدخل كلاسيكي حدثي/سردي، في الوقت الذي نتحدث فيه الآن عن التاريخ الجديد؛ تاريخ إشكالي ينبني على وضعيات إشكالية تحمل الغموض والقلق الفكري…تدفع المتعلم إلى خلخلة تمثلاته عن طريق التساؤل والتشكيك في المعرفة المقدمة إليه (شكير عكي، 2020، ص:24). أما على المستوى المنهجي فكل وحدات الكتب المدرسية تتعاطى مع المعرفة التاريخية بشكل حدثي في مخالفة واضحة لنهج المادة. ولتطوير مقاربة جديدة لتديس المادة نقترح التالي:
• أن تكون مقاربة دامجة لقيم المواطنة وبانية للهوية المغربية؛
• أن يتم تناول المعرفة التاريخية بمقاربة إشكالية تتجاوز السرد الكرونولوجي الحدثي؛
• أن يتم اعتماد مقاربات تقويمية تركز على تنمية الفكر النقدي عوض تكريس واقع الاستظهار.
2 ـ بالنسبة لمادة الجغرافيا:
عرفت الجغرافيا كعلم للمجال (Amor Belhédi. 2017, P :184) في بنيتها الأكاديمية تطورا مسترسلا يكاد لا ينتهي ، ويرجع الفضل في ذلك لانفتاح الجغرافيا على حقول شتى، مما جعل منها علما تركيبيا يتموقع في ملتقى مناهج علوم متنوعة ( GEORGE. P. 1970, P :5).
وتستمد الجغرافيا شرعية حضورها كمادة دراسية ضمن المناهج بكونها تشكل إلى جانب التاريخ، مادة أساسية لبناء الهوية الوطنية والرابط المواطناتي المبني على التاريخ والمجال المشترك. كما أنها أداة لتنمية التفكير الاستراتيجي، إذ تمكن المتعلمين من بناء المعارف والمهارات والأدوات الجغرافية التي يحتاجونها كمواطنين وكفاعلين مسؤولين بالمجال. ويبقى السؤال الجوهري مطرح هو؛ أي مضمون جغرافي يتعين تدريسه، وأي مهارات جغرافية تستدعي الإكساب؟
بالنظر إلى البرامج والكتب المدرسية الحالية، وما أُنتج حولها من أبحاث ودراسات، نقف بالملموس على نقائص وهِنَات عديدة، فطبيعة المعرفة العلمية الجغرافية المتسمة بالتفكك والتجزئة؛ بحكم تعدد الخطابات والتيارات تجعل من الجغرافيا الأكاديمية صعبة الاستيعاب وكذا تنقيلها الديداكتيكي (Philippe pinchemel, 1977, P :255 ) ونضرب هنا مثلا بوحدات جغرافيا إعداد التراب، ناهيك عما تقدمه من معارف ومعطيات/بيانات متقادمة، ومتجاوزة، وطنيا ودوليا. رغم تسليمنا بكون الجغرافيا مادة دراسية ذات معطيات متجددة باستمرار.
أما منهجيا فيبقى الوضع الابستمولوجي للكتاب المدرسي في علاقته بالمنهاج مناقضا؛ فمنطق تقديمه لوحدات المادة يتم بشكل مخالف للنهج الجغرافي، ويصبح بذلك الكتاب المدرسي معرقلا، ومؤسسا لمسلكيات تدريسية لا تتلاءم والمنهاج، خاصة من طرف المدرسين الجدد.
وضمن منحى هذا التفكير، وبغية تجاوز هذا الواقع نقترح برنامجا يعل على:
• إكساب المتعلمين مضامين ذات راهنية ومفاهيم مرتبطة بالمجال، وترسخ التفكير الجغرافي؛
• تمكين المتعلمين من مهارات الموضعة في المجال وآليات تَمَثله وتمثيله؛
• الانفتاح على نظم المعلوميات الجغرافية؛
• اكتساب قيم مجالية تتيح للمتعلمين/ات اتخاذ مواقف واعية من القضايا الجغرافية الراهنة وإشكالاتها؛
• اعتماد مقاربة الجغرافيا الإشكالية (جعل الجغرافيا منهجا للتفكير المجالي faire penser l’espace).
• اكتساب التربية على التصرف في المجال (GERARD HUGONIE , 1992, P : 12)
3 ـ التربية على المواطنة وسؤال التجديد:
تعرف التربية على المواطنة بكونها تربية، تركز على تزويد المتعلمين بمعارف عن تاريخهم الوطني وثقافتهم، وتمكينهم من قيم ومهارات من أجل المشاركة النشطة الفاعلة والمنتجة داخل المدرسة وخارجها في الحياة العامة.
إلا أن واقع الممارسة الصفية لتدريس هذه المادة (والتي وقفنا عليها في الميدان) تخطيطا وتدبيرا وتقويما، لا تعكس إلى حد بعيد مرامي المنهاج. فوحدات برنامج المادة خلال السنوات الثلاثة بالسلك الإعدادي تُلَقن تلقينا يعيد إلى الأذهان ممارسات ديداكتيكية بائدة لا تمت بصلة للبراديغم المُتبَنى والمتمأسس على المقاربة بالكفايات. كما أن بعض وحدات البرنامج أصبحت بدورها متجاوز وغير ذات راهنية.
ويستدعي تطوير المادة إنتاج برامج وكتب مدرسية، تتغيى بناء تعلمات تُكسِب الممارسة المُواطِنَة والمشاركة الفاعلة للمتعلمين في أنشطة الحياة المدرسية، والمساهمة في تدبير الشأن التربوي بالمدارس(مجالس المؤسسة، مناديب الأقسام…). ولن يتأت ذلك إلا بالانتقال من التربية على المواطنة بشكلها الحالي إلى تربية مدنية Education civique ، بما يكفل بناء المعرفة المواطناتية باعتماد مقاربات بيداغوجية نشطة تسهم في ترسيخ فعل المواطنة بالفضاء الصفي (اعتماد الوضعية بالمشكلة الكتاب المدرسي) والنقاش والتفكير النقدي. ونضع هنا بعض الموجهات منها:
• اكتساب المفاهيم والمعارف المرتبطة بالتربية المدنية ؛
• اكتساب مهارات المشاركة المدنية وحل المشكلات والتفاوض والإقناع؛
• بناء مواقف واعية، وترسيخ السلوكات الإيجابية؛
• اكتساب مهارة تَقبُّل الآخر، وحس الانتماء والقيم والأخلاق.
وختاما أمكن القول أن البرامج والكتب المدرسية لمواد الاجتماعيات تتطلب مراجعة جذرية؛ سواء على مستوى المعارف أو منهجيات الاشتغال، على ضوء ما يشهده التطور الأكاديمي للمعرفة في بعدها العالم، دوليا وجهويا ومحليا، كما تستدعي تجويد الطرق والمقاربات المعتمدة في إنتاج الكتب المدرسية والانفتاح على الكتاب الرقمي. والذي لن يكون إلا بالتحرر من ضغوطات لوبي النشر والتوزيع، وتكوين أطر التدريس، وتطوير الأطر المرجعية للتقويم وأساليبه بتغليب البعد التربوي والانعتاق من الهاجس الأمني، بما يكفل مخرجات قادرة على الاستجابة للحاجيات المجتمعية وتحقيق وظيفية مواد الاجتماعيات، وربح رهان الإصلاح المنشود.
المراجع:
محمد العيوض، تدريس التاريخ القديم بالسنة الأولى ثانوي إعدادي، منشورات المعهد الجامعي للبحث العلمي، الرباط 2012.
شكير عكي، القيم في التاريخ المدرسي، مجلة تقاطعات، العدد 2، 2020.
عز العرب معنينو، الطالب الأستاذ بين المعرفة الجامعية ومؤهلات التدريس منشورات المعهد الجامعي للبحث العلمي، الرباط 2012.
Amor Belhédi, Epistémologie de la géographie : déchiffrer l’espace, 2017
HUGONIE, Gérard, Pratiquer la géographie au collège, ARMAND COLIN, Paris.1992
Philippe pinchemel, La géographie et l’enseignement, 1977, P :255